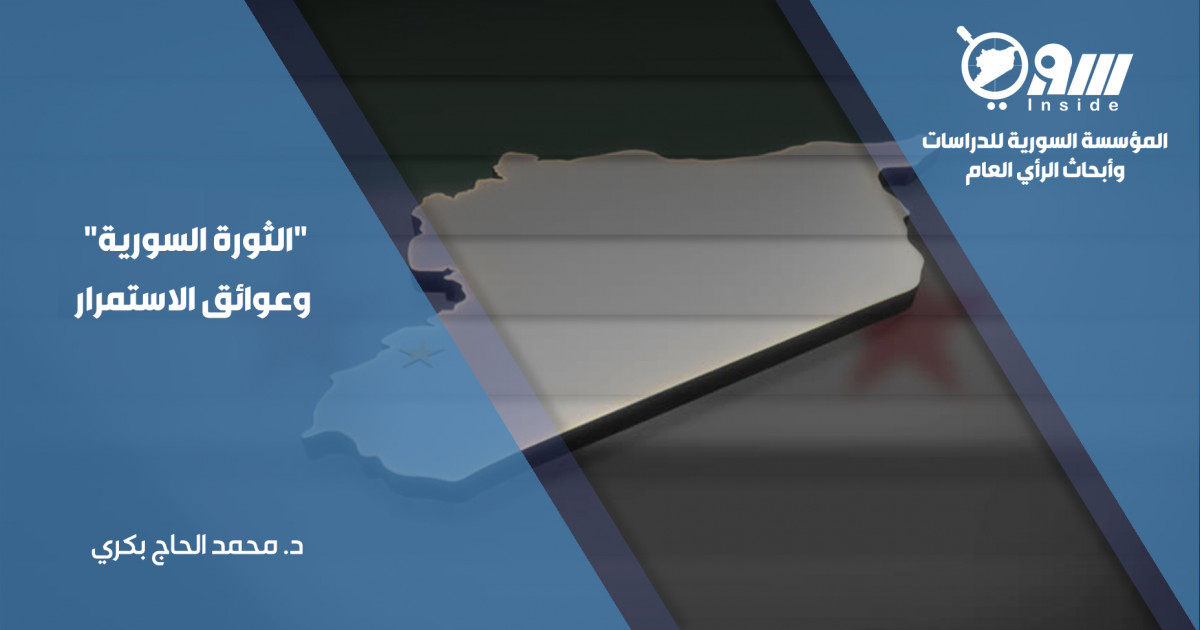تمهيد:
على مدار عقود طويلة عانت سورية من استبداد سياسي أفسد الحياة ودمر البلاد، وأعادها إلى الوراء عشرات السنين، ليتعزز اليقين بأن الثمن الذي دفعه شعبنا بالرضوخ للاستبداد أكبر بكثير من الثمن الذي كان سيدفعه لو أنه قاوم هذا العبث منذ البداية، ولكن على ما يبدو أن المستبدّ لا يُولد مستبدا، إنما تصنعه ظروف موضوعية نلخصها في بضعة أحرف “وحيث لا قطيع…لا ذئاب” إنما يظهر الذئب حين يظهر القطيع.
ويبدأ المستبد حياته بخطوة مبدئية، تتلخص في أنه يتصور نفسه قائداً ومفكراً ومعلماً ورسول العصر، ثم تأتي الخطوة الثانية فيتصور نفسه إنّه من طينة تختلف عن طينة البشر، أو إنه مبعوث الأقدار العليا لحكم الشعب.
وفي هذه الورقة نلقي الضوء على العوامل المختلفة التي أدت إلى نمو الاستبداد في سورية وحالت دون انتصار “ثورة” الحرية والكرامة التي خرجت جموع السوريين الغفيرة مطالبة بها منتصف آذار 2011.
أولا- معوقات النهوض:
1- استبداد النظام وشموليته
بعد أن ضرب الاستبداد أطنابه في أرجاء الوطن عبر القمع والقتل والنفي والتعذيب، قام “الأسد الأب” بإبعاد كبار الناس في المرتبة والخبرة ورجاحة العقل عن السلطة، وتكبيل المجتمع وإذلاله بأن قدم أقزاما ووضعهم في أبّهة السلطة يأمرون وينهون، ولكنهم في النهاية لا قيمة لأوامرهم ونواهيهم فكل الشعب يعرف أنهم جواري السلطان وخدمه وحشمه ولا يفعلون إلا ما تمليه عليهم مصالحهم وغرائزهم وأهوائهم.
وهكذا حلَّ أهل القرابة والوساطات والمفسدين في نظام الاستبداد محلَّ أهل المعرفة والكفاءة، وسقطت موازين الثواب والعقاب وظهر نوع من المسؤولين لا يتحملون في الواقع أية مسؤولية ولا يحاسبهم إلا من اصطفاهم وولّاهم مواقع السلطة ليرتعوا فيها.
وغالبا ما يعمد هؤلاء المسؤولون إلى السلب والنهب بشراهة عجيبة حتى يجمعوا أكبر قدر من الثروة قبل أن يزول عنهم السلطان بالطرد أو التصفية الجسدية، وهم لا يخشون صحوة ضمير ولا يشعرون بأنين الشعب وأوجاعه في ظل غياب الأخلاق والتربية والرقابة والمتابعة الصحيحة التي لا تنهض إلا بالديمقراطية الحقيقية وحرية الإعلام، أما إذا ما انتفت الديمقراطية وانتكست مبادئها فلا بد أن يدخل الفساد إلى دواوين المسؤولين ولا بد أن تخترق الرشوة مكاتبهم ولا بد ان تتورم جيوبهم من هول استغلال النفوذ والاتجار بالمال العام.
وكل هذه الآفات أصابت المجتمع السوري بعد “انقلاب الأسد” حيث ألغى الأحزاب وصادر الحريات وكمّم الصحافة وتسلط على الإنسان في عقله وفي ماله من خلال مركزية إدارية عنيفة ومتعفنة رعت الفساد وضاعفته حتى أصبح دستورا ونبراسا يهتدي به أفراد أفرع الأمن وكتائب البعث في تعاملهم مع المواطنين.
وبعد أن أحكم “الأسد الأب” قبضة الاستبداد جاء “الابن” ليكمل تصوراته مستخدما كل الآلة العسكرية التي حشدوها واشتروها من أموال الشعب لسنين طوال في مواجهة خاسرة ضد شعبه الذي قرر أخيرا أن ينزع عن كاهله قيود القهر والاستبداد.
وهذا المناخ العام من الفساد الذي صنعه الاستبداد في المجتمع في ظل غياب المساءلة والديمقراطية ولّد طبقة جديدة من الانتهازيين أصبحوا يشكلون عصابة منظمة داخل المجتمع ابتليت الثورة السورية بجزء كبير منهم، وباتوا ينتشرون في كل زاوية منها “كالخفافيش” وهم أصحاب السلطة الفعلية، ولا يمكن لأي صاحب مصلحة أن يفلت من شباكهم مهما بلغت قوته ومهما تعاظم شأنه؛ فالقوة والشأن عندهم للمال وحده فمن يدفع يجد الطريق أمامه ممهدا ومن لا يدفع لا يجد أمامه إلا السدود الشرعية المفصلة والتخوين.
ولا دهشة ولا عجب فهم خبراء كبار في فن القتل والفساد وقد سلحهم الاستبداد بقوانين ملتوية مبتكرة تقبل التفسير والتأويل تبعا للمزاج والغرض وشملهم بفتاوي غنية بالإجراءات الثورية والشرعية التي يطول شرحها ومن هنا كان تمكنهم وكانت سيطرتهم حتى استحقوا عن جدارة
لقب فاسدين ومُفسدين.
ويدق الخطر ويتعاظم الأمر عندما يكون هذا الفاسد المُفسد في موقعٍ حساسٍ يمسُّ أمن المواطن أو حياته أو ثورته؛ ففساد المسؤول وفساد الأجهزة الثورية وخاصة العسكرية بالإضافة الى الشرعية ينقلب وبالاً على المجتمع الثوري لأن هذه المواقع الحساسة مفترض أن تكون لها قدسيتها ولها مكانتها وبالتالي فإن هذه الظاهرة التي يتسيّد فيها هؤلاء المفسدين هي في يقيننا أخطر الظواهر المَرضيّة في ثورتنا بل هي ظاهرة لا حلّ لها إلا بزوال الأسد ومحاكمة نظامه.
2- التدمير الذاتي:
الثورة السورية من أعظم الثورات في التاريخ الحديث خاصة لناحية التضحيات الجِسام التي قدمتها، ولا اعرف كسوريٍّ عاش هذه الثورة منذ بدايتها وحتى اليوم، كيف سمحنا بتدمير أنفسنا من الداخل بالشكل الذي نعيشه؟!
لاشك أن هناك خلل عميق فينا كسوريين ينبغي تحليله وكشفه، لنعرف كيف وصلنا إلى هذه الدرجة من العجز والهوان والتخلف، ويبدو أن العوامل التي أدت إلى عجزنا في الماضي، إبان حكم الأسد، هي نفسها التي تكبل عقولنا، وتمنعنا اليوم من الحوار والتفاهم فالآفات الماضية مازالت قائمة في عقولنا وسلوكنا، لذلك، لم نستطع أن نحكّم عقولنا ونتدبر أمورنا ونصل الى تفاهم مجتمعي وآليات عمل وطنية وعقلانية تحقق اهدافنا.
وللحقيقة، ليس كل شيء من فعل مؤامرات خارجية، كما يطيب لبعض قرّاء المشهد السوري المأزوم القول للتهرب من الحقيقة والاقرار بالفجوة العميقة بين السوريين التي تتحمل وحدها المسؤولية عما حدث وعن الألغام التي تنفجر فينا في كل مكان وزمان بسبب عجزنا عن معالجتها بالكيفية الأفضل لمجتمعنا.
ليس عندي أي تفسير لهذه الظاهرة، وأنا حائر مثلكم بسبب ما يحدث في سورية بالطبع ليس لأن السوريين متخلفون، أو جيناتهم هي السبب، فالسوريون صناع حضارة ويشهد تاريخهم بعد الاستقلال بعد أن شيدوا وطنهم، غير أنهم لم يحافظوا عليه.
وهناك شعوب وأمم كثيرة عانت مثلنا من تمزق وفوضى ما بعد الثورات، لكنها نجحت في المحافظة على وحدتها، وبنت نفسها وطورت اقتصادها في زمن قياسي وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية خير مثال على ذلك.
و بعيداً عن حديث المؤامرات الأجنبية والعربية التي ليس مبالغا فيها وليست مجرد أوهام، لأننا عشناها حقيقة وواقعا من توزيع الدعم الى الاعتماد على شخصيات درسها الداعم بدقة الى إبعاد الكفاءات ومصادرة القرار الوطني، ولكن ما نشهده، اليوم، من فوضى وتدمير هو في معظمه من صنع أيدينا، إنه تدمير ذاتي للإنسان السوري وتدمير ذاتي لكثير من مكوناتنا، وتدمير لمبادئ وأهداف دفعنا من أجلها كل غالٍ ونفيس.
ولذلك يُحار المرء وهو يتساءل إن كان المسؤولون عن هذا الجنون وهذه الفوضى يعون ما يفعلونه، وهل يحدث هذا عن سبق إصرار وترصد، بفعل الارتهان للخارج أو العمالة للنظام، أم أنه نتاج الانسياق وراء حسابات ذاتية، وحماقات منفلتة من أي منطق غير منطق الجهل.
مضت سنواتٌ سبعٌ ودخلنا العام الثامن، وقد اعتقد الناس خلال هذه السنوات أن أوضاعنا الداخلية في المناطق “المحررة” سوف تتحسن تدريجيا، ولكن هذا لم يحدث، بسبب تغلب “منطق” القوة والتعصب والإقصاء على كل شيء.
لقد أصبح التدمير الذاتي سمة عامة تحكمنا، تنسف جميع مقومات وحدتنا الوطنية الداخلية، وتمزق النسيج الاجتماعي لدولتنا الواحدة، وتقسم الشعب إلى أطراف متناحرة ومجموعات مسلحة متقاتلة، فتجعل مجتمعنا أكثر هشاشة، وقابلية للاختراق والتقسيم، وربما صار عاجزا عن النهوض من جديدً. وعلى الرغم من أن ما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا، من حيث الأهداف والمصير المشترك، فقد أصبح الولاء للفصيل غاية وهدفا. كيف حدث هذا!؟ ومن المسؤول عنه، والمستفيد منه؟ هل من تفسيرٍ لهذه العقلية التخريبية، وهذا الهوس بتدمير الذات؟ هل من تفسيرٍ لفشلنا في تغليب المصلحة الوطنية والجماعية على المصالح الضيقة ؟
لقد ثار الشعب السوري على نظام مستبدٍّ وطاغٍ، دمر وطنه وشعبه على امتداد خمسة عقود لكن هذا الشعب، يجد نفسه اليوم في قلب فوضى عارمة تغيب فيها الدولة وأجهزتها وتندلع فيها صراعات تمت هندستها بعناية من أطراف عديدة، فإن استمرت قادتها حتما سنقاد إلى نظام أشد تدميراً وخطرا من “نظام” الأسد أو إلى انقسام مناطقي وجهوي متخلف، مغلّف بشعارات دينية وسياسية.
إن أزمتنا تكمن في عقولنا ونفوسنا، وفي طريقة تفكيرنا التي ترفض الآخر والتعايش معه. وتكمن في تعصبنا الديني والسياسي، والقبلي والجهوي، فالتعصب هو الذي ولّد الاحساس لدى جميع الأطراف المتصارعة بأنها على حق، وغيرها على خطأ؛ هذا التعصب هو الذي شحن بعضنا بالعداء، وبالاستعداد للقتل والذبح ولارتكاب أبشع الجرائم باسم “الثورة” أو “الشرعية” أو الدين والشريعة والشعارات السياسية الزائفة، التي تخدم أصحابها ولا تخدم الوطن وأهله، فكأن هذا البعض أصبح وصّياً على الشعب السوري يدافع عن الحق والطرف الأخر عن الباطل.
ولم تستطع المكونات الجيوسياسية والدينية والعسكرية التي نشأت خلال الثورة أن تعمل في إطار نهج واحد يتجاوز أحقاد الماضي وسلبيات الحاضر، ولم توقف صراعاتها على السلطة والثروة، ولم تتحاور لتتفق على تجميع قواها ومواجهة التحديات، ومتطلبات المجتمع السوري ولرسم سياسات مستقبلية تضمن مصالحها المشتركة في ظل وطن واحد، بل أصبح كل واحد منها يظن نفسه “الكل بالكل”.
3- غياب السلطات الناظمة للثورة
نعم! قد تغيب السلطات الناظمة وآليات العمل المشترك بفعل عوامل عديدة لكن المكونات السياسية والدينية التي ظهرت أثناء الثورة فشلت أيضا في التصدي للمهام الوطنية والديمقراطية، عندما توفرت ظروف ملائمة لأخذ مكانتها وتأدية رسالتها التاريخية في خدمة الوطن والشعب، وفضّلت جميعها، لأسباب بنيوية تحكمها وتحكم عقليات وسلوكيات قادتها، الارتماء في أحضان المنافع القبلية والجهوية والمناطقية، وتمسكت بتعصبها الديني إلى درجة التطرف.
ولذلك لم تعد المشكلة ما يجري في الرؤوس، وإنما أيضا ما يجري على أرض الواقع، بما أن الأطراف المتناحرة لا تفكر بحكمة، بل بطيش وتهوّر ومغامرة.
بينما ظل الجهل مخيِّما بقوة، لذلك صار الحَدّاد قائدا، ورجل الدين طبيبا، واختبأ القاضي في بيته لأنه ابن العلمانية والقانون الوضعي، واختلط الحابل بالنابل.
ولو أن كل إنسان في هذه المناطق أطلق صيحة حق واحدة لتحوّلَ صوت المجتمع إلى زئير يجبر الباطل على الفرار، ولو أن كل إنسان خطا خطوة إيجابية واحدة لتحولت الخطى إلى تيار هادر يكسح أمامه كل الخونة ومؤامراتهم والعملاء والمنافقين الذين زرعهم نظام الأسد في هذه المناطق، الذين تجدهم دائما يسعون إلى مكاسب لا يستحقونها على حساب الذين يستحقون.
ونحن نعيش في أكاذيب على مدى نصف قرن وهي فترة تكفي لأن يتمكن خلالها الكذب من أن يستقر في تراكيبنا الوراثية، فنحن كأفراد يَكذبُ بعضنا على بعض حتى في أبسط المعاملات اليومية من بيع وشراء. وإذا صادفنا من يصدقنا الحديث سخرنا منه واتهمناه بالسذاجة والعبط.
العالم بغربه وشرقه يعرف أننا نكذب على أنفسنا، بل نعشق الكذب ونحرص عليه ونوفر له الحماية، فراح يعاملنا على هذا الأساس، فهو يكذب علينا حينما يمتدح سياستنا ويكذب علينا حينما يشيد برجالاتنا ويكذب علينا حينما يثني على بعض علمائنا ويكذب علينا حينما يمنينا بالسلام ونحن من جانبنا نرتاح إلى هذا الكذب ونطرب له ونهلل ونردده بين الناس عبر وسائل إعلامنا.
ثانيا- التداعيات على الصعيد الداخلي والخارجي
1- على الصعيد الداخلي:
ما هي نتيجة ما يحدث والآثار المترتبة عليه بالنسبة للشعب السوري أو حتى لجزء منه؟ إنها الشلل الكلي أو الجزئي للحياة الطبيعية على المستوى الداخلي، حيث أصيب كل شيء في سورية بالشلل، وغابت حياة الناس الطبيعية، وحل محلها الخوف والهلع والترويع وغياب الأمن والأمان والاستقرار.
وما أن تنتهي أزمة أو مأساة حتى تبدأ أخرى، حتى كاد الوطن يصير “أرض الأزمات والمآسي”، وتكاثرت هموم البشر تحت وطأة سياسات الاستبداد، المدعوم من إيران وروسيا ومرتزقة الدنيا بأسرها من جهة، والفصائل المتناحرة المتحاربة من جهة أخرى، حيث يدّعي كل طرف من الأطراف المتصارعة أنه صاحب حق في ما يقوم به من تدمير للمنشآت والمباني العامة والخاصة واعتقال وتعذيب وقتل واغتيال للمدنيين والعسكريين ورجال العلم والفكر وحتى التجار.
ولا عجب أن صار سكان المدن ينامون ويستيقظون على أصوات القنابل والصواريخ والرصاص، ويجهلون متى تتوقف الضربات العشوائية أو تبدأ، ولا عجب أن ساد الفساد وعمَّ في معظم المنظمات، وأن شاعت سرقة المواطنين العزّل (أموالهم وممتلكاتهم وسياراتهم)، وأغلِقت الطرق بالحواجز وقُطِعت المياه عن مدن بأكملها، وانعدم مستوى الخدمات العامة، وغابت الكهرباء بصورة مستمرة، وساد النقص في الوقود، وانعدمت الخدمات الصحية والعلاجية، وأصبحت “المشافي” في عجز عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الناس. واخذ كل طرف يعطي نفسه الحق في شلِّ حياة المواطنين الطبيعية، دون أي اعتبار للمسائل والقضايا الإنسانية والدينية والوطنية.
ولهذا يدفع الشعب السوري بكامله ثمنا كبيرا لمغامرات ومقامرات الأطراف المتصارعة، التي لم ولن تحقق شيئا للسوريين، وستجلب لهم المزيد من الآلام والمعاناة والدمار.
إن النمط السلوكي للمجتمع السوري في تغير مستمر فقد ظهرت فئة جيد في المجتمع ذات طابع استهلاكي وهي فئة القادة والأمراء من عسكريين وسياسيين وتهدف معظم هذه الفئات إلي تحقيق المصالح مستغلة زيادة الدخل المادي، وبقية الشعب يعانى ظروف الحياة المادية الصعبة وارتفاع الأسعار والغلاء المستمر.
ومن هنا ظهرت السلبية والانعزالية والسلوكيات غير الإيجابية، وأصبح البحث عن المصلحة الخاصة من السمات الأساسية في سلوكيات المواطنين.
إن المناخ الاجتماعي الموجود في سورية يحرص على حب الذات بشكل غير طبيعي ناهيك عن انتشار ظواهر العنف والعدوانية والأنانية والحقد، وهذه الظواهر نتيجة طبيعية للواقع السوري في ظل نظام الكبت السياسي والاحتقان الاقتصادي القديم العهد وفي ظل الفوضى الحالية وغياب أي دور للقانون.
2- على الصعيد الخارجي:
على المستوى الخارجي: خسرت الثورة جزءا كبيرا من سمعتها الدولية، ومن التكافل والشجاعة والتضحية والإيثار والقيم التي بلورتها الثورة وكانت محل فخر واعتزاز القاصي والداني.
تلاشت هذه المرحلة، لأن السوريين واجهوا بعضهم البعض، في صراعات مسلحة ظاهرها المصلحة العامة وباطنها الأطماع السلطوية وطلب الثراء والانصياع للتبعية الإقليمية أو الدولية.
هكذا أصبحت بندقيتنا التي كانت حرة، مرتهنة ومؤجرة لدى الأكثرية تحت مختلف الشعارات السياسية والدينية الكاذبة، فقد شعرت كثيرٌ من الدول بأن “الأسد” لم يكن وحده المشكلة، خاصة بعد أن عجز السوريون عن التفاهم السياسي والعسكري وأثبتوا أنهم غير مؤهلين للممارسة الديمقراطية، ولا يقدّرون معنى الحرية وما يترتب عليها من مسؤوليات، ولا يقبلون التعايش السلمي فيما بينهم، وأصبحوا يعيشون تحت رحمة التقلبات الشديدة للأطراف المتصارعة التي تزداد يوما بعد يوم بدائية وتطرفا.
وكان النظام هو المستفيد الأكبر من مقاطع فيديو عن الحوادث الفردية التي ينشرها “الثوار” على اليوتيوب رغم أنها فردية ورغم أن جرائم النظام أكثر من أن تُعدَّ وتُحصى، وتشمل القتل الجماعي والتهجير والتغيير الديمغرافي واستخدام الأسلحة المحرمة وغير المحرمة.
وقد أصبحت سورية في نظر العالم الخارجي بؤرة خطر ليس فقط على داخلها، بل كذلك على جيرانها ومحيطها الجغرافي العربي والإقليمي وحتى الدولي.
وفي هذه الاجواء، تم هدر المليارات خلال السنوات الماضية، فإن أنت سمعت وحللت الأرقام التي تصرّح بها الدول، التي قدمت كمساعدات للشعب السوري، ظننت أنك في جنات النعيم، مع أننا لسنا غير بازار للقاصي والداني، بسبب افتقارنا الى الإدارة والتنظيم وعجزنا عن بناء شيء ذي قيمه بالأموال التي أعطيت لنا دون حسيب ولا رقيب، وجعلت الجميع يتهم الجميع بالفساد مما عزز فقدان الثقة في قدرة “الثورة” على القيام بأعبائها وتحقيق أهدافها.
ثالثا- متطلبات البناء:
تتطلب مسؤوليتنا أن نتبع الحق ونصلح أحوالنا، ولا نقصي غيرنا، ونرغم أنفسنا على التحاور سلميا وليس بالسلاح والقتل والتدمير، فالداخل “المحرر” دفعنا جميعا ثمن تحريره لذلك لا بد ان نتحلى بالمسؤولية التاريخية تجاه مجتمعنا، التي تقع على عاتقنا جميعا، فلن يعذرنا الزمن أو الأجيال القادمة إن وقفنا دون حراك عقلاني، فإما أن نترك مجتمعنا ينحلّ ويتفكك ويصبح لقمة سائغة لكل من هبّ ودبّ، أو أن ننتشله مما هو فيه ونبدأ بخطوة على الطريق الصحيح، مع ما يتطلبه هذا من قيام النخبة بممارسة دورها من كافة أوجهه.
وكم هو مؤلم أن نرى من تخلى عن ولائه لسوريا، ويقبل بالفواجع التي حلت بالمواطن السوري، وبالوطن إجمالا، دون أن يشعر بخيبة أمل وحزن عميق، بعد ان أثخن جسد الوطن بالندوب والجراح وتبعثر أهله في كل مكان وتعمّق انقسامهم وازدادت الفرقة بينهم، فمتى تتوقف عذابات الإنسان السوري ويعود الى حياته الطبيعية؟
هذا سؤال تصعب الإجابة عليه، فقد عاش المواطن السوري عذابات توالت عليه واحدةً بعد الأخرى منذ انقلاب البعث والأسد وتسلم السلطة وحتى الآن، دون أن يعرف فترة راحة من العبث بمصير شعبه لأن كل ما وقع من أحداث سياسية واقتصادية واجتماعية حمل معه العذاب لأغلبيته وهدم طموحه نحو بناء دولة الحق والقانون.
ولعله من مفارقات واقعنا أن مأساة المواطن السوري حقيقية، تجسدت على أرض الواقع في دولة من أغنى دول اسيا، فكأنه كتب على إنسان هذه الارض الشقاء والعذاب ولم يعد يكفيه ما تعرض له على امتداد خمسة عقود من ذل وقهر وقتل وسجن وتعذيب وتغييب عن العدالة، ونهب لممتلكاته ولثروات وطنه.
وبعد ثورة 15 آذار التي سقط فيها مئات الآلاف من الشهداء وعرفت أروع صور التضحية تجددَ الأمل لدى الشعب السوري في نيل حياة كريمة وحرّة وعادلة. لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن بسبب ضمور وزيف الوعي، وعدم إدراك أولوياتنا وعجزنا عن تنظيم مطالبنا وحاجاتنا وسيطرة أنانيتنا وذواتنا وتوجهاتنا السياسية القبلية والجهوية علينا، ونسياننا أن الوطن يستوعبنا جميعا، اذا ما تحلينا بقدر من الإخلاص والوفاء له ولشعبنا، الذي قلّ أن عرف التاريخ مثيلا لتضحياته وبطولاته وصبره.
واليوم يقف المرء حائراً ومتألماً، وعاجزاً عن تقديم يد العون، وعن وصف ما يعانيه المواطن السوري من الظلم والقهر والدمار النفسي والمادي، وهو يعايش من جديد ممارسات أقل ما يقال عنها أنها نتاج أناس بلا ضمير أو تعاطف مع الدم السوري الذي يسفك كل لحظة، أو إحساس بعذابات البشر ومعاناتهم اليومية في مناطق المعارك، حيث المدافع والصواريخ والرصاص والشظايا المتطايرة هنا وهناك لا تميز بين مسلح وأعزل، ولا تشعر برعب الأطفال المنبعث من عيونهم البريئة، أو بهموم ومخاوف النساء والشيوخ والعجزة والمرضى، أو بمشكلات اللاجئين والنازحين وتشردهم من منطقة إلى أخرى، ومن مدينة إلى مدينة، حيث يعيشون في أماكن لا تصلح غالبا لإيواء البشر، وظروف تهجير يندى لها الجبين.
ولم تقف عذابات السوريين ومعاناتهم عند حدود، أو ممارسات كالخطف والابتزاز وصعوبات السكن والمعيشة والخدمات الصحية والتعليمية والعمل ولم يعد لديهم طرق آمنة أو مؤسسات وأجهزة عاملة، أو حياة طبيعية، لذلك انتقل معظمهم إلى الحياة البدائية معيشة وسلوكاً، حتى أصبحت مفردات الألم والخوف والمعاناة علي لسان الكبار والصغار والرجال والنساء، وأصبح شائعا انتهاك الكرامات واستباحة البيوت والأعراض وصار الجميع يتساءل: من أين نبدأ وطريق إعادة بناء الدولة مغلقة بيد قتلة الأبرياء وأعداء البسطاء والشرفاء؟
من أين نبدأ، إذا كنا لم نعد نسمع قولاً صادقا، أو نرى يدا تمتد بالخير أو فكرا ينشد البناء لا الهدم؟
من أين نبدأ بعد أن تخلى عنا كثير من الناس الأهل والأصدقاء وأصبحوا في مهب العواصف وفي ظروف غير إنسانية؟
من أين نبدأ قبل أن يجتاحنا الحريق، ويضيع منا الطريق، وتُسدّ أمامنا الأبواب؟ ماذا لو أن كل أبناء الوطن تدفقوا الى بلادهم وتقاسموا أعباء العودة؟ ماذا لو أنهم جاؤوا جميعهم متعانقين، وأزاحوا خلافاتهم وأحقادهم وأنانيتهم كرمى للوطن، وسعوا إلى من شغف بحبه، ونادوا أهل الثورة وشرفاء الوطن كي يلتمّ شملهم، ويقدموا خططا وحلولا تفيد شعبهم.
لقد طال بنا الزمن، وأصبحت لدينا ذرائع ومبررات للتصعيد والصراع والعنف، ولتجييش الرأي العام الداخلي بعضنا ضد بعضنا الآخر، ولمطالبة الرأي العام الدولي بدعم التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية وبلادنا، فكيف ينجو وطننا وأهله من فشلنا في التفاهم والتوافق على رعاية سورية في حاضرها ومستقبلها… أم هو صومال جديد.
ومن يحرر سورية من العبودية والذل والهوان؟ من يموت من أجلها؟ إذا كان إنسانها مهمشاً مقهوراً لا يملك قوت يومه ومُطاردا في ذهابه وإيابه .
لقد دمر نظام الأسد أغلى وأثمن شيء يعتز به إنسان وهو الانتماء للوطن؛ الوطن الذي هو الأب والأم والأسرة، وهو الحماية والوقاية والرعاية والمظلة التي يستظل بها المواطن في المحن والنكبات، الوطن الذي هو المساواة الحقة في الحقوق والواجبات وهو المشاركة الدائبة في صنع المصير، والوطن بهذا المعنى هو الذي نحيا ونموت من أجله وهو الذي نحبه ونفتديه.
ولكن عندما تحول الوطن إلي مرتع للفوضى وسرقة الموارد وسجن للأبرياء من أبنائه وظلم وقهر فباختصار شديد لا نتوقع انتماء ولا عزة ولا كبرياء ولا إحساس بالمواطنة ولا وحدة وطنية على حساب أشلاء الشعب.
رابعا- نتائج وتوصيات
إني على ثقة بأن هذا الشعب قادر على أن يصنع حاضره ومستقبلة بيد أبنائه البررة في داخل الوطن مهما كانت الظلمة حالكة والأنواء عاصفة، ومهما تعرض هذا الشعب لصنوف التضليل والتزوير لتجهيله وسلب ارادته، ومهما كانت الهجمة عليه شرسةً لتركيعه والتقليل من حجم التضحيات التي دفعها أفرادا ومجموعات مدنيين وعسكريين باهظة الثمن، ولا استسلام أو لا تراجع مهما شكك السياسيون والمنتقدون بالعجز والتشاؤم في إمكانية أن ينتصر الشعب السوري على جلاديه لأن الشعب السوري شعب حي؛ شعب يضرب جذوره سبعة ألاف عام في الحضارة الإنسانية.
ولذلك فإننا اليوم بحاجة إلى ثورة ثقافية إلى جانب الثورة السياسية والعسكرية وبحاجة إلى مثقفين يقومون بدورهم في بناء الوعي، رغم صعوبة الطريق، وبحاجة إلى قادة سياسيين ليسوا مرضى بداء “الأنا”، نحن بحاجة إلى قادة يعملون بجهد وكفاءة وتواضع ويعملون لتوافقات سياسية، ويجدون الحلول الوطنية لمشكلات الثورة، درءا للكوارث التي تحل بشعبنا الذي لم يبخل بأرواحه ومهجه على وطنه.